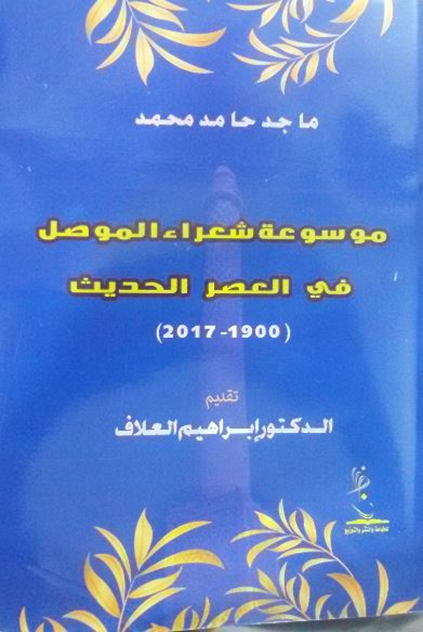الهويّة الثقافية للمهـمّش
في رواية (رجل المرايا المهشمة) للبنى ياسين
د. وجدان الخشاب
المقدمة
مشكلة البحث: انطلق البحث في مساره لدراسة رواية (رجل المرايا
المهشمة)، للكاتبة لبنى ياسين(1) محاولًا
الإجابة عن الأسئلة التالية:
1/ ما الهوية الثقافية على المستويين: الفردي
والاجتماعي؟ وما تأثيرها حضورًا أو فقدانًـا عليهما؟
2/ ما هو التهميش الاجتماعي وما دوافعه ونتائجه؟
3/ مَن هو المهمّش على المستويين: الاجتماعي في الواقع
العياني، والروائي في رواية (رجل المرايا المهشّمة) للبنى ياسين؟
4/ كيف تمثّـلت عناصر الهوية الثقافية في رواية (رجل
المرايا المهشمة)؟
5/ الى أي مدى نجحت الرواية مدار البحث في الكشف عن حالة
التهميش لدى شخصياتها؟
أهمية البحث: اختارت الباحثة الكتابة في هذا الموضوع لما يمتلكه التهميش
من حضور لافتٍ للنظر والـتأمل في الواقع العياني سواء أكان على مستوى العالم، او
على مستوى وطننا العربي، مما أدّى الى اهتمام الأُدباء بهذا الموضوع في نتاجاتهم
الأدبية بشكل عام، وفي الرواية مدار البحث بشكل خاص، أعانها على هذا الاختيار عدم
وجود دراسة أكاديمية سابقة تناولت هذا الموضوع فيها.
هدف البحث: يهدف البحث إلى الكشف عن الكيفية التي حضر فيها التهميش
في الرواية مدار البحث، وتجليات عناصره من خلال دراسة الهوية والثقافة بشكل عام،
والهوية الثقافية الخاصة بالمهمّش.
حدود البحث: تحدد البحث بدراسة رواية (رجل المرايا المهمشة) للكاتبة
لبنى ياسين.
الحد الزماني: 2012م.
الحد المكاني: حارة فرعية من حواري دمشق الشعبية.
منهج البحث: اقتضت الطبيعة الاجتماعية لهذا البحث - التي تحاول الكشف
عن الهوية الثقافية للمهمش في رواية (رجل المرايا المهشمة) - الاعتماد على المنهج
الوصفي التحليلي لكونه " الطريقة المنظمة لدراسة حقائق راهنة، متعلقة بظاهرة
أو موقف أو أفراد أو أحداث أو أوضاع معينة بهدف اكتشاف حقيقة جديدة أو التأكد من
صحة حقائق قديمة وآثارها والعلاقات المنبثقة عنها وتفسيرها وكشف الجوانب التي
تحكمها".(2)
مصطلحات البحث:
الهوية: هي مؤشّر انتماء الإنسان الى وطن ومجتمع، وهي وسيلة
تمايز يدرك من خلالها بأنّـه يختلف عن الآخرين من حيث الاسم والجنس والتركيب الجيني
والبناء الفكري والثقافي.(3)
الثقافة: طرح روبرت بيرستد تعريفاً للثقافة بأنّـها "ذلك
الكل المركب الذي يتألف من كل ما نفكر فيه، أو نقوم بعمله، أو نمتلكه كأعضاء في
مجتمع".(4)
الهوية الثقافية: تعني التفرد الثقافي بكل ما يتضمنه معنى الثقافة من
أفكار ومعتقدات وعادات وتقاليد واتجاهات وقيم وأساليب تفكير وعوامل تاريخية تراثية
وبيئية جغرافية وإبداعات لغوية وفنية وغير ذلك من خصائص وصفات تحدد شخصية المجتمع
وسماته البارزة التي تميزه عن أي مجتمع آخر مع امكانية تفاعل مجموع هذه المكونات
مع غيرها من الثقافات الاخرى، دونما انغلاق أو انبهار أو ذوبان.(5)
المهمَّش: هو "ذات مقصاة من المركز، ومن ثم فإن العلاقة بينها
وبين المهمين على المركز... علاقة قوامها الصراع".(6) إنّ هذه التعريفات ستكون بمثابة تعريفات إجرائية للبحث.
هيكلية البحث:
أولاً: التمهيد: المدخل النظري
المحور الأول: الهوية
مفهوماً لغوياً واصطلاحياً:
يكشف
المنظور اللغوي للفظة هويّة عن اشتقاقها من الجذر اللغوي (هوى) حيث ذكر ابن منظور
أنَّ هَوى يهوي: هَبَطَ، وهُوى: صَعدَ. وهَوَى يهوي هُوِيِّـاً: إذا أسرع في
السير.(7) فهي تشير
الى ثلاث دلالات
مختلفة هي: الصعود والهبوط والإسراع وكلّها تختصّ بالحركة.
ويتخذ الفعل
(هوى) معنى لغوياً آخر هو" الميل والعشق ويكون في الخير والشر، وهويَ فلانٌ
فلانا – هوى: أحبّـه. فهو: هَوٍ. وهي: هويّةٌ".(8)
توجّـه الباحثون
في تعريف الهوية من المنظور الاصطلاحي أكثر من توجّه، حيث نجد أنَّ الجرجاني يشير
الى أنّها الحقيقة المطلقة المشتملة على الحقائق اشتمال النواة على الشجرة في
الغيب المطلق.(9) لكنَّ طروحات علماء علم الاجتماع أسهمت بشكل كبير في منح
الهوية تعريفات أكثر دقةً واشتمالًا، حيث أصبحت " تعني الذات، أو الجوهر، أو
التساوي والتوافق والثبات على الأصل".(10)
وتطرح نادية
محمود مصطفى تعريفًـا آخر للهوية حين تحددها بكونها " كل ما يشخص الذات وما
يميزها وهي السمة الجوهرية التي توجد الاختلاف بين الأفراد والجماعات بل وتبرزه
بين الثقافات وعلى هذا الأساس يمكننا القول بأن الوظيفة الأساسية للهوية هي حماية
الذات الفردية والجماعية مما يمكن أن ينزع عنها وما يميزها ".(11) فالهوية إذًا تمنح ذات الفرد تميزًا عن غيره من الأفراد،
وفي الوقت ذاته تربطه بالمجتمع الذي ينتمي إليه، فتحميه بذلك من الضياع، وهو الدور
نفسه الذي تلعبه مع المجتمع.
أمّـا اليكس
ميكشيللي فيعرِّف بالهوية على انّها " مركب من المعايير الذي يسمح بتعريف موضوع
أو شعور داخلي ما، وينطوي الشعور بالهوية على مجموعة من المشاعر المختلفة كالشعور
بالوحدة والتكامل والانتماء والقيمة والاستقلال والشعور بالثقة المبني على أساس من
ارادة الوجود".(12) فهو هنا قد
ربط الهوية بالمعايير والمشاعر التي تبني شخصية الفرد، وتمنحه تفرّده المستقل الذي
يمنحه ارادة الوجود الإنساني، فمن خلال هذه التعريفات يتضح بأنَّ الهوية تشتغل باتجاه
منح الفرد تشخيصاً وتمييـزًا ومكانًـا في هذا العالم، وتبني روابطه مع المجتمع
الذي يعيش فيه، كما تمنح المجتمع أيضًا سماته التي تميّـزه عن غيره من المجتمعات، وبالتالي
فهي في منظورها الاصطلاحي تختلف عن منظورها اللغوي العربي اختلافاً جذرياً.
وفي المقابل
اتجه الباحثون أيضاً الى طرح الفكرة القائمة على أنَّ " الإنسان الواحد ينقسم
الى قسمين: هوية وغيرية".(13) فالإنسان ذات
وهو في الوقت نفسه هو غير بالنسبة لإنسان آخر؛ لأنَّ " ذاتي لا تكون حقيقية إلا بالنسبة الى الغير ومع الغير، فالغيرية
ضرورة حياتية، لا يمكن الاستغناء عنها لأنها أس كل تجمع بشري، قد تأخذ هذه الغيرية
صبغة عدوانية، فتحدد ذاتي عندئذ بالاختلاف الجذري عن الآخر ".(14) وبذلك أصبح ربط الإنسان بغيره مسألة أساس لأنَّ الإنسان اجتماعي بطبعه، والمجتمعات
لا تتكون إلاّ من الذات والغير، وتفاعلهما الذي سينتج ترابطًـا عميقًـا يسهم في
تكوين هوية لأفراده. وفقدان هذه الهوية سيؤدي الى اغتراب الفرد داخل مجتمعه، وهذا
ما سيحصل حين" تنقسم الذات على نفسها، وتتحول مما ينبغي أن يكون الى ما هو
كائن، من امكانية الحرية الداخلية الى ضرورة الخضوع للظروف الخارجية بعد أن يصاب
الإنسان بالإحباط ".(15) وهذا الاغتراب
سيعمل على تكوين " ردّي
فعل متضادين مثل العزلة والانطواء أو الانتشار والعنف".(16) وهما ردّان سلبيان ناتجان عن شعور الفرد بفقدان هويته الذاتية الخاصة به،
والخضوع للآخر بقسرية تفقده توازنه الداخلي بسبب فقدانه للشعور بالانتماء الحقيقي
لمجتمعه، وهذا ما سيدفعه الى اتخاذ واحد من اتجاهين متضادين سلبيين، الأول هو
الانطواء على الذات مما سيحرمه من الرابطة الحميمة التي تربطه بالمجتمع الذي يعيش
فيه، والثاني هو نشوء رغبة اعتماد العنف في تعامله مع أفراد مجتمعه.
المحور الثاني: الثقافة مفهومًا لغويًـا واصطلاحيًـا:
يشير المنظور اللغوي للفظة
(ثقافة) الى اشتقاقها من الجذر اللغوي (ثقف)، حيث انَّ "ثَـقِـفَ الشيء ثقـفاً وثقِـافاً وثقوفه:
حذقه، ورجل ثَـقْـفٌ: حاذق ويقال: ثقف الشيء وهو سرعة التعلم".(17) أي التمكُّن من التعلّم، ولم يخرج الفيروزآبادي عن هذا المنظور حين أشار
الى دلالة الألفاظ (ثقفا وثقاف ثقافة) صار حاذقا فطنا.(18)
إنَّ المنظور الاصطلاحي للفظة
ثقافة أصبح يختلف اختلافًـا كبيرًا عن منظورها اللغوي، حيث نجد أنَّ مالك بن نبي
يشير الى أنّ الثقافة هي " مجموعة من الصفات الخلقية، والقيم الاجتماعية التي
تؤثر في الفرد منذ ولادته، وتصبح لا شعورياً العلاقة التي تربط سلوكه بأسلوب الحياة
في الوسط الذي ولد فيه ".(19) وبذلك ربط ابن نبي بين الصفات الخلقية والقيم المجتمعية
التي تشتغل باتجاه تمييز الأفراد داخل المجتمع الواحد، وتمييز المجتمعات بعضها عن
بعض، بما تتوارثه عبر الأجيال بشكل تلقائي، وبالتالي فهي أساس العلاقة المتشكلة
بين الفرد ومجتمعه، فتكون الثقافة بذلك وسيلة تواصلية تمكن الإنسان من بناء
العلاقات مع الآخر، وبهذا يتحقق الانتماء بينهما.
وأشار العالِم الانثروبولوجي ادوارد
تايلور الى أنَّ الثقافة مُركبّة لأنها " ذلك الكل المركب الذي يشمل المعرفة
والمعتقدات والفن والأخلاق والعادات وكل القدرات والعادات الاخرى التي يكتسبها الانسان
بوصفه عضوا في المجتمع".(20) هنا نجد أنّ تايلور أكدَّ على البُعد الاجتماعي؛ لأنَّ الثقافة ترتبط ارتباطًـا وثيقًـا
بالمجتمع الذي ينتمي إليه الفرد، وتحكمه معتقدات وقدرات وعادات تميّزه عن غيره من
المجتمعات.
ويرى تيري ايجلتون أنَّ "
الثقافة ليست فقط ما نعيش به إنها أيضا والى حد كبير ما تحيا من أجله، الوجدان،
العلاقة، الذاكرة، القرابة، المكان، المجتمع المحلي، الاشباع العاطفي، البهجة
الفكرية، الاحساس بمعنى أساسي وجوهري".(21) فيؤكد من خلال تحديده لمكونات الثقافة على مسألة الانتقال الزماني للإحساس
الوجودي، فما (نعيش به) من معطيات هذا الإحساس في الحاضر وتوارثناها عن جيل سابقٍ
لنا زمانيًـا، نعيش بها حاضرًا ومستقبلًا لكون الثقافة إرث اجتماعي مستمر لأنَّ
الأجيال تتناقله فيما بينها، وتحرص عليه، فهو عامل من عوامل التوافق بين أفراد
المجتمع حيث يعمل على توجيه وضبط سلوك أفراده.
المحور الثالث: الهوية الثقافية مفهوماً مجتمعياً:
يشير غي روشيه الى علاقة
الهوية بالثقافة من خلال فكرته التي تقول بأنّ "الهوية الثقافية عالم عقلي
أخلاقي رمزي، مشترك بين أعداد من الناس، وبفضل هذا العالم ومن خلاله يستطيع هؤلاء
أن يتصلوا فيما بينهم ويقرروا الروابط التي تشد بعضهم الى بعض والقيود أو المصالح
المشتركة ويشعروا اخيراً أن كل فرد على حدة وجميعهم كجماعة بأنهم أعضاء في كيان
واحد يتجاوزهم ويشملهم جميعا".(22) وسبق أن أشار البحث الى انّ الثقافة تضمُّ الصفات الخُلقية والقيم
المجتمعية المتنوعة والتي تُـعـدُّ وسيلة من وسائل التواصل والضبط الاجتماعي،
وتعمل على تشكيل شخصية كلِّ فرد فيه ضمن ضوابطها المتعارف عليها. فالهوية الثقافية
تجمع بين معطيات الهوية والثقافة وتصهرهما معاً.
إنَّ الهوية الثقافية شأنها
شأن الكائن الحي فهي ليست جامدة بل هي "كيان يصير، يتطور، وليس معطى جاهزا
ونهائيا، هي تصير وتتطور إما في اتجاه الانكماش، وأما في اتجاه الانتشار، وهي
تغتني بتجارب أهلها ومعاناتهم، انتصاراتهم، وتطلعاتهم، وأيضا باحتكاكها سلبا
وايجابا مع الهويات الثقافية الاخرى التي تدخل معها في تغاير من نوع ما". (23) فالثبات الذي تُعرَف به الهوية الثقافية ثبات نسبي وليس مطلق التوجهات،
لأنَّ المجتمعات الحيّـة ليست منغلقة أو منطوية تمامًـا بل ان الانفتاح مهما كان
نسبيًـا هو سمتها، ولهذا نجد أنَّ تجارب أفراد المجتمع، وما يتعرضون له من مواقف
سلبية كانت أم ايجابية تثري هويتهم الثقافية، وفي الوقت ذاته ترسم خطوط تواصلهم مع
المجتمعات الأُخرى التي تمتلك أيضًا هوية ثقافية تميّـزها.
وتؤكّد المنظمة العربية
للتربية والثقافة والعلوم على أنَّ الهوية الثقافية هي " النواة الحية
للشخصية الفردية والجماعية، والعامل الذي يحدد السلوك ونوع القرارات والأفعال
الأصيلة للفرد والجماعة، والعنصر المحرك الذي يسمح للأمة بمتابعة التطور والإبداع،
مع الاحتفاظ بمكوناتها الثقافية الخاصة وميزاتها الجماعية التي تحددت بفعل التاريخ
الطويل واللغة القومية والسيكولوجية المشتركة وطموح الغد".(24) من هنا يمكننا القول أنَّ الهوية الثقافية أشبه ما تكون بالكائن الحي الذي
ينمو ويتطوّر ويتغيّر الى أن يكتسب خصائصه التي سيعتمد عليها ويورِّثها لأجياله
القادمة التي ستعمل أيضاً على تطويرها بما يناسبها.
من خلال طروحاته حدد اليكس
ميكشيللي عناصر الهوية الثقافية بما يلي:
1/ العناصر المادية والفيزيائية: تتمثل بالحيازات التالية: الاسم والسكن
والملابس، والسمات المورفولوجية.
2/ العناصر الثقافية والنفسية: تتضمن النظام الثقافي أي: العقائد والأديان
والرموز الثقافية، ونظام القيم، وصور التعبير الأدبي والفني، والعناصر العقلية مثل
النظرة الى العالم والاتجاهات والمعايير الجمعية والنظام المعرفي مثل السمات
النفسية الخاصة.
3/ العناصر النفسية الاجتماعية: تشتمل على الأسس الاجتماعية مثل: المركز:
العمر، الجنس والمهنة والسلطة والدور الاجتماعي والانتماءات والقدرات الخاصة
بالمستقبل مثل القدرة الامكانية ونمط السلوك.(25) ونظـرًا لشمولية هذه العناصر سيلجأ البحث الى اعتماد ما ورد منها في رواية
(رجل المرايا المهشمة) بما يثري مسيرته البحثية.
يؤكّد اوسفالد شفايمر على ارتباط
الأدب بالهوية الثقافية حين يشير الى أنّ الأدب " هو تكوّن هويتنا الثقافية
والفردية متجذرة في هياكل مرتبة من التعبير والتصور ومن أشكال الفكر والفعل وأشكال
الشعور والإرادة والتي تعد لنا نمطاً لتوجيه حياتنا".(26) فالعلاقة بين الأدب والهوية الثقافية علاقة متفاعلة يعمل التعبير اللغوي
على اظهارها وترسيخها في أذهان الأفراد لتكون معطياتها نمطـًـا حياتيـًا مُوجِّهًـا
لهم، وهذا ما أكّده جابر عصفور في تحديده للعلاقة القائمة بين الهوية الثقافية
والأدب حيث يقول "إننا نكتسب هويتنا من خلال طريقة وحيدة تتمثل بتعلم أشكال
تعبيرنا وإدراكنا وأفعالنا وتفكيرنا – التي هي أشكال لشعورنا ولإرادتنا – من خلال
رموز بيئتنا الثقافية، وبنفس الوقت من خلال تدعيم رموز حياتنا الخاصة".(27) فالهوية الثقافية حين ترتبط بالأدب تنتج أدبًـا واقعيًـا، لأنَّ الأدب
الواقعي هو " الأدب الذي يقوم على ملاحظة الواقع وتسجيله".(28) وحين يتمثّـل الأدب بالحضور الروائي فإنَّ الرواية الواقعية تقوم "
بالالتفاف نحو الواقع أو العكوف عليه وهو التفاف فرضته التحديات الحضارية والحركة
السياسية والتطورات الايديولوجية".(29) وهذا الالتفاف هو الذي منح الرواية فرصًا كبيرة في تكوين علاقاتها بالمجتمع
من حيث كشفها لهويته الثقافية وابراز عناصرها، ووظائف هذه العناصر من خلال
الشخصيات الروائية التي ستعيش تجاربها في العالم الروائي سواء أكانت ايجابية أو
سلبية، كما ستكشف عن الدوافع التي ستدفع بهذه الشخصيات لاتخاذ مواقف معينة قد تتغايّـر
وتتعاكس مع ايجابيات الهوية الثقافية.
المحور الرابع: التهميش مفهومًـا لغويًـا واصطلاحيًـا
كشفَ
المنظور اللغوي للفظة هَمشَ أنَّ هَمَشَ الرجل هَمْشاً: أكثرَ الكلام في غير صواب،
وهمشَ القوم: تحرَّكوا.(30) فهي تشير الى
الكلام الذي لا فائدة له ولا صحة، كما تشير الى حركة القوم.
أمّا في المنظور الاصطلاحي فنجد
أنّ الباحثين في علم الاجتماع قد تناولوا مفهوم التهميش من مختلف جوانبه؛ لأَّن
علم الاجتماع هو أكثر العلوم الإنسانية قربًـا من الحياة المجتمعية وظواهرها،
والتهميش ظاهرة اجتماعية وثقافية واقتصادية وانثروبولوجية، فكان واحدًا من المفاهيم
التي تناولها هذا العلم كاشفًـا عنه مفهومًـا وعناصرًا وأسبابًـا ونتائجًـا،
منطلقًـا من مجموعة معطيات أفرزتها حياة الإنسان في واقعه العياني حيث يشير عادل
ابراهيم شالوكا الى أن التهميش هو " جملة من الإجراءات والخطوات المنظمة التي
على أساسها توضع الموانع أمام الأفراد والجماعات، حتى لا يتحصلوا على الحقوق
والفرص والموارد وخدمات السكن والصحة والتوظيف والتعليم والمشاركة السياسية وغيرها
من الحقوق المتاحة للمجموعات الاخرى، والتي هي أساس التكامل الاجتماعي".(31)
وهذه الإجراءات والخطوات ستخلق حالة من الاستبعاد الاجتماعي والاقتصادي
والسياسي التي يعانيها الأفراد في المجتمع، وتؤدي الى إقصاء وحرمان مادي ومعنوي،
ونقص في الحقوق الإنسانية، والقدرات والفرص والخيارات المتاحة أمام الأفراد، وخلل
في المشاركة الاجتماعية.(32)
تعددت أسباب التهميش في
المجتمع الحديث فقد يكون سببه النوع أو الدين أو المعتقد السياسي أو الفقر أو
المستوى الاجتماعي أو العرق أو اللون.(33) وهذا ما أنتج مجموعة من المفردات الواصفة لها مثل: الاستبعاد الاجتماعي،
الإقصاء، الحرمان، القهر، الرفض وبذلك " يلعب التهميش دوراً محورياً في تشكيل
نظرة المهمشين للحياة والذين يتخيلون دائما أنهم خارج إطار الحياة الطبيعية
للبشر".(34) وخارج إطار المجتمع الذي ولدوا وعاشوا فيه ولكنه يرفضهم.
وهنا يتساءل البحث مَن الذي يلعب دور السلطة التي تتخذ هذه المواقف؟
إنّه المركز بالتأكيد، حيث يحاول
منح ذاته سلطة مركزية تتيح له اتخاذ القرارات وتنفيذها، تلك القرارات التي تجعل من
بعض أفراد المجتمع مبعدين أو مقصيين منطلقًـا من مجموعة أسباب جعلت من هؤلاء
خارجين عن النُظم والمعايير التي أقــرَّها المجتمع، وعمل على الحفاظ عليها، وبذلك
تنشأ بين المركز والهامش علاقة تفاعلية تحمل في طياتها الكثير من السلبية والسلطوية
والتضاد بينهما، وسيكشف عنها البحث في ثناياه.
وبما أنَّ الأدب عمومًـا والرواية تخصيصًا
صوت للمجتمع ومرآة لهمومه وأفكاره وتطلعاته أي هويته الثقافية فقد نال المهمشون
فيها اهتمامًـا كبيرًا سواء على المستوى العالمي أو على المستوى العربي. وقد أكّـد
محمد طرشونة على وجود ظاهرة التهميش في أي مجتمع من المجتمعات قديمًـا وحديثًـا،
لكن عوامل معينة قد تساعد على استفحالها في بعض الحقب، فتتحول من ظاهرة اجتماعية
الى ظاهرة أدبية.(35) يتناولها الأُدباء
في نتاجاتهم شعرًا ونثرًا. ولم يكن طرح موضوعة التهميش في الرواية العربية مجرد
رغبة في التنوّع، إنّما أصبح مجتمع المهمشين، وكشف ما يلاقيه هذا المجتمع من تهميش
وإقصاء يمثِّـل رؤية للعالم تختلف عن الموقع النمطي للروائي الذي يتعامل مع الهامش
بشكلٍ متعالٍ، فينظر إليه باعتباره موضوعًـا للسرد.(36) وتقع رواية (رجل المرايا المهمشة) ضمن هذا الإطار الذي سيلقي الضوء على
المهمشين ومعاناتهم، ليس بوصفهم موضوعًـا سرديًـا بل موضوعًـا اجتماعيًـا له
دوافعه وأسبابه التي يتخذها المركز حجةً لممارسة التهميش سواء أكانت هذه الاسباب
تتأتى من وعي ودراسةٍ وتخطيط مسبق، أو كانت نتائج لمواقف ضاغطة على المركز دفعته
لاتخاذ التهميش وسيلة انتقامية من الآخر الذي قد يكون بريئًـا ولكن وقع عليه
التهميش، وهذا ما سنكشف عنه في ثنايا البحث.
ثانياً: الجانب
التطبيقي
ملخّص رواية (رجل المرايا المهمشة):
في بيئة يصمها
الفقر بوصمه يولد صطوف، ذلك الإنسان الذي يعيش عذاباته وعقده النفسية؛ لكونه طفل
خطيئة لم يكن له ذنب فيها، ذنبه الوحيد هو تعرّض أُمّه دلال لاغتصابٍ من قبل صاحب
العمل الذي يشتغل عنده زوجها أجيرًا، ولكنَّ هذا الاغتصاب ليس هو الوحيد الذي
تعرَّضت له دلال بل اغتصبها الفقر قبله، فأنتج امرأة مهمَّشة كارهة لحياتها التي
انتهت بالجنون والموت، وكارهة لصطوف الذي حكمته مجموعة من العُـقـد جرّاء تهميشه
المتعمد، مما دفع به الى ارتكاب جريمة أودت به الى السجن، والى تهشيم وجهه بفعل
شعوره بالذنب.
المبحث الاول: تمثلات العناصر المادية
والفيزيائية للهوية الثقافية:
تتمثّل العناصر المادية والفيزيائية للشخصيات الروائية في اسماء الأعلام
الإنسانية وألقابها، وسماتها من الملامح والصفات الخارجية للشخصية مثل الطول
والقصر والوسامة والقبح والصحة والإعاقة والجنس (الذكر والأُنثى)، كما تتمثَّـل في
السكن والملابس أيضًا.
سيحاول
البحث الوقوف عند اسماء الأعلام الإنسانية التي تؤدي وظيفة تحديد الشخصيات
والتمييز بينها، لما يملكه هذا التحديد من قدرة على تمييز كل شخصية عن غيرها، فالشخصية
فلسفياً هي " وحدة الذات بما فيها من وجدان وفكرة وارادة وحرية
واختيار".(37) ولهذا يعتمد الروائي
غالباً على خاصية الانتقاء فيما يمنحه من اسماء لشخصياته" فالتسمية أبسط
أشكال التشخيص، وكل تسمية هي نوع من أنواع البعث والإحياء وخلق الفرد".(38)
وتمنح خاصية الانتقاء في اطلاق اسماء الأعلام الإنسانية على الشخصيات
الروائية حرّية للروائي في اعتماده على واحدة من دلالتين: إمّا المطابقة أو
المفارقة، وتتحقق المطابقة حين يدل اسم العلم على الشخصية المرسومة دلالة إحالة
وتطابق على أكثر من مستوى، مثل: الأوصاف والمزايا والأفعال، مما يسمح للاسم أن يكون
دالًا معنويًـا مطابقًـا للشخصية، لأنَّ " الكاتب يسعى الى أن تكون اسماء
شخصياته معبرة عن دور الشخصية ووظيفتها".(39)
أما الدلالة الثانية فهي دلالة المفارقة، ويتمثّـل حضورها عند اختيار الروائي
اسماء تتناقض وتتعاكس مع صفات الشخصية أو مزاياها أو أفعالها في المسار الروائي،
ولهذا سيحاول البحث التوقف عند ثلاث من شخصيات
رواية (رجل المرايا المهشمة) قارئا دلالة الاسماء التي اختيرت لها من قِبل الكاتبة
الروائية لبنى ياسين، والكشف عن العلاقة بين الاسم وحالة التهميش التي يعانيها
المُسمّى:
1/ صفوت:
شخصية رئيسة في الرواية مدار البحث، ويشير المعنى اللغوي للفظة (صفوت) الى
انَّه المختار والأفضل، أمّـا لقبه فهو (صطوف)، وهو لقب شائع في المجتمع السوري
الشعبي. إنَّ دلالة (المختار والأفضل) لا تنطبق على شخصية صفوت في مسارها الروائي،
فهو ابن الخطيئة الذي ولد نتيجة اغتصاب أبي نعيم لدلال ليلة غياب زوجها ديبو عن
البيت، فهو لم يكن مختارًا بل كان عبئا على دلال التي حاولت التخلص منه بشتى الطرق
في فترة حملها به دون أن تفلح، وكرهته منذ أن كان جنينًـا في رحمها، ورفضته عند
ولادته، حيث " مضى أسبوع والرضيع مرمي عند الجارة لا يسأل عنه أحد، ولا اسم
له، ولا وجود".(40) وهذا أول وجهٍ
من وجوه التهميش الذي تعرّضت له شخصية صفوت، حيث تساوى وجوده وعدمه، لكنَّ ديبو
حاول أن يمنح صطوف وجودًا إنسانيًـا من خلال تعيين اسم له، فسأل دلال عن الاسم
الذي ستختاره، فقالت له" سمه ما شئت.. سمه (ابليساً) إن أردت".(41) وكانت دلال أثناء المخاض قد
سمَّته (ابن الشيطان)، وبما أنَّ (ابليس – الشيطان) يحملان دلالة لغوية واحدة هي
المُبعَـد من الخير ومن رحمة الله فإنَّ صفوت وأبوه الحقيقي (أبو نعيم) مبعدان من
رحمة الله ومن رحمة دلال أيضاً، بل بالعكس لن تمنحه إلا الابعاد والإقصاء والتهميش
الذي حرمه بدءا من ولادته هوية ثقافية داخل عائلته. بمقابل هذا السلوك من دلال كان
على ديبو أن يمنح المولود اسمًـا شخصيًـا، وبالتالي هويّـة وقبولًا داخل العائلة،
فاختار له اسم (صفوت)، وكان اختيارًا عشوائيًـا حيث أنَّ أحد الأشخاص استوقفه
ليسأله عن منزل شخصٍ اسمه صفوت، ورغم أنَّ ديبو لا يعرفه "إلاّ انه اعتبرها
اشارة له بتسمية الصغير".(42) إشارة غيبية
أتاحت له تسمية الصغير الذي لم يعرف بأنه ابن خطيئة وليس ابنه هو.
وبما أنَّ الرواية مدار البحث حملت توصيف (رجل المرايا المهشّمة) عنوانًـا،
والمقصود به صطوف، فلا بُدَّ لنا من الوقوف عند العنوان حيث يُعدُّ "مرسلة
لغوية تتصل لحظة ميلادها بحبل سري يربطها بالنص لحظة الكتابة والقراءة معًـا،
فتكون للنص بمثابة الرأس للجسد، نظراً لما يتمتع به العنوان من خصائص تعبيرية وجمالية
كبساطة العبارة وكثافة الدلالة واخرى استراتيجية إذ يحتل الصدارة في الفضاء النصي
للعمل الادبي".(43) فعنوان الرواية مدار البحث عنوان مركب محمَّل بالتلميح الى صطوف، فهو " رجل
المرايا المهشمة التي لا تستطيع أن تعكس إلا صوراً ممزقة بإخراج غارق بالقبح".(44) فالمرايا تعكس ما يقع على وجهها، وتكشف حقائق وجوهنا، إلاّ ان صطوف منذ
سنوات طفولته " تعلم أن المرايا لا تصادق أشخاصاً مثله، ولا تلقي عليهم تحية
الصباح، إن صدف والتقت بهم وجهاً لوجه".(45) لأنّها ستعكس التشويه الخُلقي الذي يغطي خده منذ ولادته، وفي ذات الوقت
ستضع ما يعتمل في نفسه من مشاعر أمامه فلا يرى فيها ما يسعده أو يمنحه أمانًـا
واستقرارًا، بل سيجد ذاته المتشظيّة والقبيحة معًـا، وهذا ما أشعره بفقدان الثقة بنفسه
وهامشيته أيضًا.
2/ دياب:
تُعـدُّ لفظة دياب تحرَّيفًـا عاميّا للفظة ذئاب، ومفردها ذئب، وهو من
الحيوانات التي تتصف بالقوة والجرأة والشجاعة والوحشية والذكاء، أمَّا لقبه (ديبو)
فهو تصغير للفظة دياب، وتصغير الاسم قد يدل على الاستلطاف، وهذا ما قصدته والدته
من تصغير اسمه، وقد يكون التصغير أيضًا مؤشِّرًا لدلالة عكسية هي التحقير والتشهير.
لنتابع مسيرة شخصية دياب، ونستكشف دلالاتها، فمن وجهة نظر أُمّـه "
كانت تُشعِره بأنه إنسان استثنائي". (46) لأنّـه يمتلك صفات: الذكاء والفطنة والطيبة والنبل. وفي المقابل يواجهنا
توصيف زوجته دلال له بأنّه " رجل معدم الأحلام منعدم الأحاسيس".(47) و" محدود القدرات، لا طموح لديه، ولا أدنى ثقافة". (48)
ومن
وجهة نظر مجتمعه نجد أنَّ" الناس لا يرونه أصلًا كأنما هو ظل شفاف لكائن لا
يستحق الذكر".(49) أمَّا الراوي
فنجده يؤكِّـد أنّه " رجل
سلبي لا يكاد يتخذ موقفاً تجاه أي شيء في حياته".(50) و" مسالم حد الاستسلام". (51) و" هادىء حد الموت".(52) و" لم يكن لديه اصدقاء ولا حتى اعداء".(53)
ومن وجهة نظره الخاصة - بعد موت
أُمه- " علم في قرار نفسه أنه لن يجد من يقدره، ويرفع من معنوياته ".(54) ولهذا وجد نفسه وقد " تحول الى كائن غير مرئي، ولن يكون في وسعه رؤية
ملامحه حتى في المرآة.. وسيشتاق لنفسه كثيراً، ولملامحه التي لم تعد هنا".(55) بناءً على ما سبق يمكننا القول بأنَّ الأُم هنا هي الشخصية الوحيدة التي
منحت ديبو هوية ثقافية داخل مجتمعه لما رأت فيه من صفات جميلة، أمّا الشخصيات
الأُخرى فقد عمدت الى تهميشه وتجريده من هويته الثقافية وبالتالي من وجوده، مما
انعكس سلبًـا على نظرته لنفسه وهو يشهد تحـوّله الى كائن غير مرئي، وبلا ملامح،
فبدا استسلامه واضحًـا لوجهة نظر الآخرين فيه، وهي وجهة نظر أفقدته هويته
الثقافية، ومنحته تهميشًا واضحًـا يفارق دلالة اسمه.
3/ ناجي:
اختارت دلال اسم (ناجي) لابنها البكر؛ لأنه ولدَ بعد أن قذف رحمها بأجـنّة
ميتة لمرتين متتاليتين، ولم يعارض ديبو بل راقته الفكرة لأنَّها " تحمل
دلالات على النجاة والسلامة".(56) ولكنَّ تتبُّع سلوكيات هذه الشخصية في المسار الروائي تكشف عن شخصية
أنانية، مطالبها تُنفَّـذ بدلالٍ لا تحدّه حدود، وهو لا يهتم بأي فردٍ من عائلته
رغم المشاكل التي حلّت بها، واهتمامه الوحيد هو تحقيق حلمه بأن يصبح طبيبًـا،
ويتزوج زوجة من عائلة ثرية وراقية، يقـلِّـدها ويتبعها في كل شيء، وما إن حقق حلمه
حتى أصبح هذا التحقق " بداية للانسلاخ من حارة لا يريد أن يدخلها بعد ذلك،
ومجتمع يخجل من انتمائه إليه، ويجد نفسه أرفع من مستواه وأعلى".(57) وبذلك تحققت دلالة المطابقة بين سلوكيات شخصية ناجي واسمها على مستويين:
الأول نجاته من الموت، وهذا شيء قدريّ، والثاني نجاته من الفقر، ومن الأب (ديبو)
الذي كان يحمّله "جريرة موت أمه، وجريرة الفقر الذي عاشوا فيه". (58) والعائلة التي يراها لا تشرّفه، والحارة التي يخجل من انتمائه إليها،
فتصوّرَ أنّه بانسلاخه من هويته الثقافية أصبح مركزًا ، وتخلَّـصَ من حالة
التهميش، إلاّ ان هذا الموقف له وجه آخر لا يمكن لنا إلاّ أن نصفه بالسلبية والتهميش،
فقد انطلق من أسرٍ الى أسرٍ آخر، ومن تهميش الى تهميش آخر حيث استبدل ناجي بعد
زواجه من امرأة ثريّـة " طريقة أكله ولبسه، وحركاته وسكناته".(59) ليصبح تابعًـا ذليلًا لزوجته وعائلتها الثريّـة التي أخذ يقـلِّدها في
كلِّ شيء، فكان هامشًا جوهريًـا ولكنه المركز الغني والمرموق مظهريًـا.
يُشكِّل السكن العنصر الثاني من العناصر المادية والفيزيائية للهوية
الثقافية، والسكن يفترض مكانًـا للعيش لأنّ الوجود الإنساني لن يتحقق بشكلٍ فعليّ
إلاّ بوجد مكان يحتويه ليمارس فيه حياته اليومية الطبيعية. ويرتبط سكن الإنسان في
المكان ارتباطًـا جذريًـا بفعل الكينونة للعيش والوجود، وفهم الحقائق وصياغة
المشروع الإنساني. (60) وفي رواية (رجل
المرايا المهشمة) يعلن الراوي أنَّ عائلة صطوف تعيش في بيتٍ " في حارة فرعية
من حواري دمشق الشعبية، حيث تساند البيوت العشوائية بعضها بعضاً، وتقف كتفاً الى
كتف في مواجهة الفقر الذي يتربص بكل بيت من بيوت تلك الحارة".(61) وبما أنَّ الفقر هو " عدم القدرة على تحقيق مستوى معين من المعيشة
المادية يمثل الحد الأدنى المعقول والمقبول في مجتمع ما من المجتمعات في مدة زمنية
محددة". (62). فالفقر في هذه الرواية سيلعب دوره الكبير في تهميش
شخصياتها، لأنّ تأثيره لا يتوقف عند حدود الحالة الاقتصادية بل يمتد ليشمل الحالة
الاجتماعية والثقافية أيضًا، وهذا ما سيشير إليه راوي الرواية مدار البحث حين يصف
معيشة دلال في بيتها، فهي " حبيسة غرفة متواضعة في منزل لا يعدو غرفتين
صغيرتين وحماما ومطبخا".(63) حيث قطع
الأثاث القديمة و" تلك الجدران المتآكلة تذكرها بقلب يصدأ كل يوم دون أن
تتمكن من تفعل له شيئاً واحداً يعفيها من طعم الانكسار المر، ورائحته
الواخزة". (64) هنا يكشف
الراوي عن معاناة شخصية دلال ووعيها الذي يعلن وجوده بوصفه وعيًـا ذاتيًـا
مُحاصرًا بالفقر وخيبة الأمل والانكسار بعد زواجها وحرمانها من حلمها بأن تكون
مهندسة ديكور؛ لتحقق أفضل صورة لوجودها الإنساني بإبداعها في عملها، لتتحوّل الى
شخصية مهمشة في بيتٍ لم ترغب به، وزوج أُجبرت على العيش معه.
وبما أنَّ دلالة البيت العائلي تنهض من خلال علاقة ساكنيه به فإنَّ دلالة
بيت دلال تشير الى افتقاره الى الدفء والألفة الأُسرية بل تحوّل الى سجنٍ حُبست
فيه، وقُيّدت حرِّيتها، فأصبحت شخصية مهمشة تفتقد أبسط حقوقها الإنسانية. لكنَّ
البيت من وجهة نظر غاستون باشلار هو جسد وروح، وهو عالم الإنسان الأول، فالحياة
تبدأ بداية جيدة، تبدأ مسيّـجة، محمية دافئة في صدر البيت. (65) وهذا ما يتعاكس تماماً مع حقيقة شعور دلال في بيتها، والذي يتعاكس في الوقت
ذاته مع حياة ووجود ابنها صطوف الذي فرضت عليه العيش في ركن قصيّ في زاوية الغرفة
بفراش أرضي، "وفصلته بستارة قماشية سميكة عن بقية الغرفة بما فيها ومن
فيها".(66) لا لتمنحه خصوصية مميزة بل حوّلته الى سجين في بيت
الأُسرة، يعيش مهمشاً في فضاء مغلق جعل منه شخصية منغـلقة على ذاتها بفعل الإقصاء
والحرمان من الدفء والحنان والترابط العائلي المُفترض وجوده في بيت العائلة؛ لأنّ
العائلة هي أول المؤسسات التي تشتغل باتجاه تكوين شخصية الفرد، وتُعدّه للاندماج
مع مجتمعه، هذا الاندماج الذي تعمّـدت دلال حرمان صطوف منه لأنّه " كان
الدافع اليومي لإعادة شريط الذكريات المؤلم". (67) فوجود صطوف أمام ناظري دلال كان أشبه بمثير كريهٍ
يُذكِّرها باغتصاب أبي نعيم لها، وبالتالي فإنَّ صطوف هو ابن الخطيئة المغضوب
عليه، والذي لا يستحق _ من وجهة نظر دلال _ إلاّ حرمانه من هويته الثقافية بالتهميش
والإقصاء والعزل الإجباري.
لننظر الى
بيت دلال ذاته من زاوية أُخرى وهي علاقة ساكنيه بالجيران حيث يكشف لنا الراوي أنَّ
شخصية ديبو تعاني من الانغلاق أيضًا، وهذا ما سنجده عندما حاول الجيران التقرُّب
منه بزيارة عائلية " رد عليهم السلام بسلام فاتر". (68) و" وتركهم ومضى الى الغرفة الثانية، وكأن أمر هذه الزيارة
في بيته لا يعنيه مطلقاً".(69) إذاً شخصية ديبو هي الأُخرى شخصية منغلقة فرضت على نفسها انعزالاً عن
جيرانها، ولم تعمل على توليد علاقات وروابط مشتركة مع الآخرين في مجتمع تقوم فيه
العلاقات مع الجيران بخلق روابط متينة تعمل على تماسك وتآزر أفراده، وتمنحهم
هويتهم الثقافية التي تميّزهم عن غيرهم من المجتمعات، فأصبحت حالة التهميش متبادلة
بين عائلة ديبو وجيرانه.
بعد وفاة أُمّـه وزواج أبيه وأخويه أصبح صطوف يشعر بأنّه عبء على أبيه
وزوجته، ولم يعد يشعر بانتمائه لهما، فـفكَّـر بالاعتماد على ذاته، والاستقلال في
السكن بعيدًا عن منزل أبيه " منزل صغير قريباً من عمله، يستمتع فيه
بوحدته".(70) تلك الوحدة التي فرضتها عليه أُمه منذ ولادته، فلم يشعر
بحياة أسرية تربطه بها ارتباطًـا حميمًـا؛ لأنَّ الطفل يصبح اجتماعياً حينما يكتسب
القدرة على الاتصال بالآخرين والتأثير فيهم والتأثر بهم فيصبح الفرد عن طريقها
مندمجًـا في جماعة اجتماعية من خلال تعلم ثقافتها ومعرفة دوره فيها.(71) وهذا الاندماج لم يتحقق لصطوف أبدًا، ولم يشعر به والده أيضًا، وهذا ما
يخبرنا به الراوي حيث "توقع أن يرفض والده خروجه ولو من باب المجاملة، وفوجىء
بترحيبه السريع بالفكرة". (72) فبدا الأب وكأنه
يريد هو الآخر الخلاص من صطوف وتهميشه.
ويستمر البيت في حضوره الفاعل في حياة صطوف، فحين استأجر بيتًـا شعر به
" قصراً منيفاً، مقارنة بركنه المنزوي الذي لا يشغل غيره في منزل أبيه".(73) فـرغم صغر حجم هذا البيت وبساطته إلاَّ ان شعوره بالحريّة
والخلاص من القيود التي فُرضت عليه تهميشًا وإقصاءً في منزل العائلة جعلت من بيته
الصغير قصرًا رحبًـا يشعر بانتمائه إليه رغم وحدته.
لم تستمر وحدته طويلاً لأنّه تزوّج بمها التي أثارت فيه رغبة تكوين عائلةٍ
يعيش معها حياةً أُسرية سويّةً وايجابية، لكنّه عرف أنَّ والدها اغتصبها، وكان
يتردد على بيت صطوف تحكمه رغبة دفينة في استمرار اغتصابه لها بعد زواجها أيضًا،
لكنَّ صطوف رفض هذا الأمر رفضًا قاطعًا، و" قرر أخيراً أنه سيطرده من منزله
مهما كان الثمن.. وإن عجز فسيغير عنوان بيته، ويستأجر بيتاً آخر يودع فيه زوجته
بعيداً عن ذلك الفاسق، هارباً من المواجهة التي يعجز عنها".(74) لكنَّ قرار الطرد يستوجب مواجهةً صارمة يدافع فيها صطوف عن زوجته وعن شرفه
وحرمة بيته، ويدفع عنه أيضَا هذا التهميش الذي عمل والد مها على فرضه عليه وعلى
ابنته، ولم يستطع صطوف مواجهة الوالد ولا طرده من بيته ولا من حياته مما جعل مها
تهرب من البيت؛ لأنها تأكدت من عجزه، فأصبح البيت سجنًـا كان لا بُـدَّ لها أن
تكسر قضبانه وتهرب منه، وهنا بدا أنّ حالة التهميش أصبحت مرفوضة من قِبل مها بعد
أن كانت مفروضةً عليها جبرًا، فيما كان صطوف غارقًـا في مأساته، و" دارَ
غاضباً في المنزل عدة مرات كثور جريح" (75) لأنّه لم يستطع كسر قيود التهميش الذي فـرّغَ هويته الثقافية
من محتواها.
تُـعـدُّ الملابس العنصر الثالث من العناصر المادية والفيزيائية للهوية
الثقافية للفرد، وهي ضرورة من الضروريات الأساسية والثابتة للإنسان، حيث اتخذها
لستر وحماية جسده أولًا ثم أخذت مع تقدُّم الزمن أبعادًا متنوعة منها الثقافية
والمجتمعية والسيكولوجية، وأصبحت علامة من علامات تمييز المجتمعات عن بعضها البعض،
فلعبت بذلك دورًا كبيرًا في الكشف عن شخصية الإنسان بوصفها الجلد الثاني لهيكله
الإنساني كما أشار تومي كاريل:" وما جسم المرء وملابسه إلا البقعة التي
عليها، والمواد التي بها يُشاد ذلك الهيكل الرائع الفخم: شخص الإنسان". (76) ولهذا اهتمت الدراسات الانثروبولوجية بدراسة الملابس والأزياء منطلقة من
فكرة أنَّ الملابس" وسيلة تكيف مع البيئة من ناحية، ورمز له دلالته في تحديد
هوية الإنسان، وخلق الاحساس بالانتماء، كما أنها امتداد للجسم".(77)
لنستكشف شخصية صطوف في علاقته مع الملابس حيث يعلن الراوي أنّه أُجبر على ارتداء
ملابس أخويه لأنهما طلبة في الجامعة، " أما هو فمن يأبه به، وعلام ارتداؤه
لجديد الثياب؟ أمن أجل أبيه أم من أجل أبي نعيم؟! بالتأكيد ليس لأجل نفسه..".(78) وهذه صورة مضافة من صور تهميشه، فلم يُمنح ملابسًا تخصه وحده، ولا أحد من
عائلته يهتم به، بل أنّها عملت على تجريده من إحساس الانتماء والمساواة مع أخويه؛
لكونهما طلبة في الجامعة التي حُرم أيضًا منها، وتحدد عالمه الشخصي بحدين: أبيه
وأبي نعيم الذي يعمل عنده أجيرًا، فحُرم من حقّه في أن تكون له شخصيته المستلقة
ليصبح تابعًـا مهمشًا لا قيمة له.
بمقابل
هذا السلوك العائلي التهميشي قرر صطوف أن يمنح ذاته فرصتها في إعلان وجهٍ من وجوه
هويتها الثقافية مستغلًا مناسبة زواج أخيه ناجي، فعمد الى الذهاب " خلسة الى
محل بيع ألبسة رجالية، واقتنى لنفسه قميصاً وبنطالاً". (79) مما منحه الشعور " بسعادة غامرة وهو يجرب ثيابه الجديدة، وبدا له أن
شكله القبيح سوف يصبح أكثر وسامة مما تعود عليه، أو ربما أقل قبحاً مما عرفه
سابقاً".(80) هنا يبدو التعزيز النفسي الذي صنعه صطوف لنفسه خلسةً واضحًا
حيث " يلعب الملبس المناسب دوراً يشجع على الاندماج في الحياة الاجتماعية".
(81) لكون الملابس الجديدة رسالةً تحيل دلاليًـا الى الوجود
الإنساني الحيوي، فحاول صطوف أن يرسل رسالته التواصلية الخاصة الى الآخرين معلنًـا
لهم شعوره بأنه أصبح أكثر وسامةً وأقلَّ قبحًـا، فيمكنه بالتالي أن يحقق الانتماء
للعائلة، والاتصال بالآخرين من خلال المشاركة في حفل الزواج دون أن يكون مقصيّـا
ومُـبعـدًا من عائلته ومن الآخرين أيضًا، لكنَّ زوجة ناجي رفضت حضور صطوف للعرس،
مما دفع به الى اعادة الملابس الى المحل واسترجاع نقوده" متجاهلاً جرحاً
عميقاً جديداً ينزف في شرايينه، فتطفو مشاعر الخيبة فوق أنهار الدم الهارب، ويغص
بطعمها رجل يكره ملامحه كل يوم أكثر".(82) إنَّ الرفض هنا ليس رفضًا لحضور العرس كما يبدو ظاهريًـا بل هو تهميش
وإقصاء في جانبه العميق، حيث لعبت العروس دور المركز السلطوي الذي أقصى صطوف
وأبعده تمامًـا عن الاندماج الاجتماعي الذي كان يحلم به، وهذا ما أثار عاملًا
نفسيًـا تمثّـل في شعوره بالخيبة الناتجة عن رفض المجتمع لاندماجه به، ذلك الشعور
الذي حطّـمَ فرحته كما حطّـمَ تقديره لذاته، فأصبح يكره ملامحه كلَّ يوم أكثر، مما
عمّـقَ لديه الشعور بالتهميش والاستبعاد.
المبحث الثاني: تمثّـلات العناصر الثقافية والنفسية
للهوية الثقافية:
تسهم العناصر الثقافية والنفسية في تشكيل الهوية الثقافية للأفراد في
المجتمع، ولا تقتصر وظيفتها على التشكيل فقط بل انّها ستعمل على توجيه وضبط السلوك
الفردي. وذلك من خلال قيام الأُسرة بدورها الثقافي في تهيئة وإدماج الابناء في
الإطار العام للمجتمع عن طريق ادخال التراث الثقافي في تكوينه وتوريثه توريثًـا
متعمداً، فعن طريق الأُسرة يكتسب الطفل لغته وعاداته وعقيدته، ويتعـرّف على طريقة
التفكير السائد في مجتمعه، فينشأ منذ طفولته في جو مليء بهذه الأفكار والمعتقدات
والقيم والأساليب، إذ تعمل الأُسرة على تزويد الابناء بثقافة المجتمع.(83). من هنا ينطلق الإقناع في حضوره من تواضع أفراد المجتمع عليها وتوارثها
جيلًا بعد جيل، لتصبح بالتالي معيارًا لإصدار الأحكام على سلوكيات الأفراد داخل
المجتمع، وتمنحهم هوية ثقافية تميزهم عن المجتمعات الأُخرى في الوقت ذاته،
متمثِّـلة في العادات والتقاليد والمعتقدات والأعراف والقيم التي تعمل على تكوين
نظرة الفرد الى العالم المحيط به. فالعادات هي تلك الأشياء التي تداول الناس على
القيام بها أو الاتصاف بها، وتكرر عملها حتى أصبحت شيئا مألوفا، وهي نمط من السلوك
أو التصرف يُعتاد حتى يُفعل تكرارًا، ولا يجد المرء غرابة في هذه الأشياء لرؤيته
لها مرات متعددة في مجتمعه وفي البيئة التي يعيش فيها.(84)
ويلتقي تعريف التقاليد مع تعريف العادات في كينونتهما المشتركة. حيث أنَّها
تمثِّـل ما انتقل الى الإنسان من آبائه ومعلميه ومجتمعه من العقائد والعادات
والعلوم والأعمال.(85) كما يرتبط
العُرف المجتمعي أيضًا بالعادات والتقاليد ارتباطًـا وثيقًـا. حيث ترى فوزية ذياب
أنّه ذلك النوع من العادات الواسعة النطاق في انتشارها، التي ليست في مصلحة جماعة
بالذات بل في مصلحة الجماعات كلها، متلاقية في وحدة واحدة هي المجتمع أو الأُمة.(86) فهي أُمور يلتزم بها أبناء المجتمع فاتسمت بسِمة التكرار، وقد تقوم غالبًـا
مقام القوانين الوضعية في المجتمع، مما يمنحها وظيفة الضبط الاجتماعي الذي يستدعي
الالتزام بها، وقد يُعاقب مَن يخالفها من ابناء المجتمع بتعرّضه للسخرية أو
الاستهجان أو القتل أحيانًـا حسب قرار المجتمع.
من العادات والتقاليد المتعارف عليها في أي مجتمع بشريّ تبادل الزيارات بين
الجيران، لكنَّ الراوي في رواية (رجل المرايا المهشمة) يخبرنا أنَّ ديبو لا يعترف
بهذه الزيارات بل يفضِّـل قطع العلاقات مع الجيران، بدليل تعمّـده بتحيتهم تحية
باردة " وهروبه لغرفته من كل ضيف، ووجهه الممتعض بوضوح".(87) فكان لهذا السلوك التهميشي أثره الكبير على علاقته بالجيران
الذين أصبحوا " يذهبون الى غير رجعة".(88) هذا من جهة، كما كان له أثره على دلال من جهة ثانية مما " جعلها تؤثر
الوحدة على شبح الاستغراب والاستنكار الذي يرتسم مرة إثر مرة على وجه
زوارها".(89) وهذا بالتالي يدلل على تهميش ديبو للعلاقات الطيّـبة مع
الجيران.
ومن العادات والتقاليد أيضاً أن يتناول أفراد العائلة وجبات الطعام سوية
لما فيها من أثر في بناء وتفعيل الترابط الأُسري، لكنّ دلال بوصفها مركزًا
سلطويًـا فرضت على صطوف أن ينزوي في ركن صغير من المطبخ ليتناول طعامه، فيما يجلس
بقية أفراد العائلة لتناول الطعام سوية، وهذا وجه آخر من وجوه إقصاء واستبعاد صطوف
عن العائلة، وتهميشه أيضًا.
إنَّ المعتقدات من الأمور التي يؤمن بها الشعب فيما يتعلق بالعالم الخارجي
والعالم فوق الطبيعة (الأمور الغيبية)، ومن الشائع أن يُطلق عليها في الماضي اسماً
ينطوي على حكم قيمي واضح، إذ كانت تُسمّى الخرافات. (90) وترتبط الطقوس بالمعتقدات ارتباطًـا عميقًـا؛ لأنَّ الطقوس هي " مجموعة
حركيات سلوكية متكررة يتفق عليها ابناء المجتمع" (91) تحضر المعتقدات الغيبية وطقوسها في رواية (رجل المرايا المهشمة) حضورًا
فاعلًا من خلال شخصية دلال بعد ولادتها لصطوف، وما أبدته من كُـرهٍ ونفورٍ منه ومن
زوجها ديبو، وإقناع جارةٍ لها بضرورة زيارة الشيخ التلمساني، هذا الشيخ الذي
أقنعها بأنَّ كرهها لولدها وزوجها سببه السحر الذي حُـضِّـرَ لها، أو بسبب
القرينة، ووعدها بأنَّه سيخلصها منهما، داعياً إيّـاها لحضور (الحضرة)، وهو طقس
يقيمه لأمثالها حيث يجمع " نسوة تفوح منهن رائحة الخيبة واليأس".(92) في غرفة ليس فيها سوى سجادة حمراء، ونوافذها مغلقة، وتُقرع الدفوف "
فتدور النسوة حول أنفسهن متراقصات". (93) " حتى يصلن الى حالة من الدوار الشديد توقعهن أرضاً دون حراك".(94) والهدف من هذا الطقس هو جعل النساء يشعرن و" كأنهن بعثرن همومهن في
حلقات مفرغة". (95)
لم يكتفِ المشعوذ التلمساني بإقناع دلال بالمشاركة بهذا الطقس بل أقنعها
بحضور الحضرة الخاصة التي يقيمها للنساء اللواتي أحبَّـتهن الكائنات الأُخرى،
وفضَّلتهن على النساء الأُخريات، واقتنعت دلال بكلامه وشاركت في هذه الحضرة، حيث
رَتَّـبَ المشعوذ تفاصيلها من خلال ظهور " أشكال غريبة تبدو كأقزام ارتدوا
ثياباً مزروعة بمصابيح صغيرة، أو قطعاً دائرية من القماش الفسفوري".(96) ولإكمال حالة الإقناع كان المشعوذ التلمساني يسأل الكائنات عن حالة كل
واحدةٍ من النساء المشاركات في الحضرة وعلاجها، ولكنَّ التأثير السبي لهذه الحضرة
ظهر عليها فمنذ ذلك اليوم " عادت دلال امرأة أخرى، وقد فقدت شيئا من اتزانها،
وضيعت جزءا من عقلها في ذلك المكان".(97) إنَّ المعتقدات الغيبية وطقوسها التي تعتمد على الدجل والخداع المُقنِع لها
تأثير مباشر على فكر الإنسان يتخذ ظهوره من خلال ما يتأثر من مشاعر الإنسان وسلوكه
بها، ولهذا نجد أنَّ دلال أُصيبت بالجنون إثر عودتها من طقس الحضرة الخاصة، حيث
بدأت تعلن عن رؤيتها لكائنات صغيرة تلاحقها وتلاحق ولديها ناجي وسالم لتؤذيهما،
كائنات لا يراهم سواها، وهذه علامة من علامات الجنون الذي دمَّـر تكوينها العقلي
والنفسي كما دمَّـر حياتها العائلية، فكان تهميشاً مضافاً أخرجها من نطاق حياتها
الإنسانية السويّـة الى حالة الجنون التي أفقدتها هويتها الثقافية، واستفحلت حتى
أوصلتها الى الموت.
حدد الباحثون في علم الاجتماع القيم بأنَّها ضوابط سلوكية تؤثِّـر في أفكار
ومعتقدات الإنسان، وهذه الضوابط تضع سلوكه ضمن قالب مُعيَّـن يتماشى مع ما يريده
المجتمع ويفضله.(98) فالمجتمع هو
الذي يصدر هذه الضوابط ويقيد أفراده بها، وهذا ما منحها فرصتها في أن تكون عنصراً
من عناصر الهوية الثقافية. فهي كما يشير فولسوم " نمط أو موقف أو جانب من السلوك الإنساني أو مجتمع أو
ثقافة أو بيئة طبيعية، أو العلاقات المتبادلة التي تمارس من شخص أو أكثر، كما لو
كانت غاية في حد ذاتها، إنها شيء يحاول الناس حمايته والاستزادة منه والحصول عليه،
ويشعرون بالسعادة ظاهريا عندما ينجحون في ذلك ".(99). فالإنسان بوصفه عضوًا في المجتمع ينطلق بفعل الثقافة الى
حمل القيم وتفعيلها في واقعه اليومي المعاش، وبذلك تعمل على تفعيل التماسك
الاجتماعي، كما تعمل على منح الفرد فرصة التعبير عن نفسه من خلال اتباع سلوكيات
تتوافق مع قيم المجتمع، التي ستعمل بالمقابل على ردع الفرد الذي يخالفها وينحرف
عنها، وإلاّ سيكون عقابه الرفض والاستهجان ليكون عبرةً لغيره ممن تسوِّل لهم
أنفسهم خرق هذه القيم.
تتنوع القيم السائدة في المجتمع، فمنها قيم أخلاقية ومنها اجتماعية أو
دينية أو شخصية. سيحاول البحث التوقف عند الشرف بوصفه قيمة أخلاقية اجتماعية يحرص
عليها أفراد المجتمع من خلال التزامهم بها، حيث يخبرنا الراوي أنَّ دلال أثناء
اغتصاب أبي نعيم لها استسلمت له؛ لأنها " كانت تنتقم من الفضيلة التي بسببها
بترت أحلامها وأُلقي بها في هذا المكان العفن، ليس عقاباً على ذنب اقترفته، بل
خوفاً من ذنب قد تقترفه فتلوكها الألسن، تنتقم من نفسها، ومن زوجها، ومن أمها،
وحتى من أبيها الذي رحل عنهم فوقعت الدنيا فوق رأسها بسبب ذلك".(100) فالشرف والفضيلة من القيم المجتمعية التي تحرص عليها النساء قبل الرجال في
مجتمعنا العربي، لكنَّ دلال تمثِّـل هنا رمزًا كاشفًـا لكل امرأةٍ تهمّـش بسبب
ذنبٍ (قد) تقترفه أي أنّـه يقع في خانة (الاحتمال) فتحاكم ويصدر عليها الحكم قبل
أن تقع في خطيئةٍ تستوجب عقاب المجتمع لها، ولهذا كان ردّ فعل دلال على هذا الموقف
استسلامًـا للمغتصب ليكون انتقاماً، فالاستسلام هنا ردّ فعلٍ وليس فعلًا، ولكنه
أثار ألمها وحزنها بعد الاغتصاب، حيث يعلن الراوي أنَّ " أكثر ما أوجعها
فعلاً هو استسلامها الذي لم تستطع أن تعطيه تفسيراً يبرد حر انتهاكها
لقيمها".(101) فانتهاك القيم المجتمعية ليس سهلًا؛ لأنّه سيستدعي
فضيحةً لن تستطيع ردّها فمَـن " يسكت ألسنة الناس عن لوك كرامتها
وشرفها؟!".(102) فالمجتمع
سيعاقب مَن ينحرف عن قيمه بتهميشه واستبعاده، ولهذا استباحها " إحساس مقيت
بالعار والذل يستوطن كل خلية من خلايا جسد انتهك للتو".(103) فرغم استسلامها لحظة الاغتصاب انتقامًـا إلاّ ان اللحظات التي تلته جعلت
منها فريسة لصراع نفسي، تحكّم به خوفها من معطيات الفضيحة التي تمثّـلت بخوفها من
زوجها إن علم بما حصل ربّـما سيقتل أبا نعيم عقوبة له على فعله الشنيع ويدخل
السجن، فتضيع مرّة ثانية مثلما ضاعت في المرّة الأُولى عند وفاة والدها، أو قد
يصدر حكمه عليها بطردها من المنزل واقتلاع صغيريها منها، وهذا الطرد والاستبعاد
إنّـما هو عُرف اجتماعي ينفِّـذه الزوج ليكون المخطىء عبرةً لأمثاله، وبذلك سيتحقق
تهميش آخر الى تهميشها التراكمي، ويفقدها هويتها الثقافية داخل المجتمع.
بالمقابل
نجد موقف أبي نعيم يختلف كليّـا عن موقف دلال فقد " خطا بهدوء ودون أدنى
ارتباك باتجاه الباب تاركاً وراءه جسداً انتهكه العار والخجل".(104) حيث تكشف صورة حركته عن سلوك ذكوريّ سلطويّ لا يعترف بقيم الشرف والفضيلة
والعـفّة التي انتهكها دون أن يقيم وزناً لحرمة امرأة انتهك شرفها، ولا لمجتمع
انتهك قيمه الأخلاقية، هنا تبدّت حالة التهميش وضياع الهوية الثقافية لدلال واضحة
من خلال عملية الاغتصاب، ومن خلال عقوبتها أيضًا. أمّا أبو نعيم فقد احتفظ بهويته
طالما أنّ عملية الاغتصاب مسكوت عنها، ولم تُعلن للمجتمع، وبذلك نجا من أي نوع من
أنواع العقوبات التي ستفرَض عليه في حالة الانكشاف.
المبحث الثالث: تمثّـلات العناصر
النفسية الاجتماعية للهوية الثقافية:
تتمثّـل هذه العناصر بمجموعة متنوعة من المكونات التي تتداخل مع بعضها تداخلًا
كبيرًا رغم تضاداتها مثل المكونات الانفعالية التي تضـمُّ في حقلها كل من: الميل
الى الانطواء والانبساط، والتوافق الشخصي والاحباط والعدوان والقلق، والصراع
النفسي والعصبية، وقلة الصبر والتوتر، والميل للسيطرة والسلطة أو الخنوع.
يرى سكوت جون أنَّ " التنشئة
الاجتماعية مفهوم يقر بأن الهويات الاجتماعية والأدوار والسير الذاتية الشخصية
تتكون من خلال عملية متواصلة من الانتقال الثقافي".(105) سواء أكانت هذه التنشئة على مستوى المجتمع ككل أو على مستوى الأُسرة التي
هي النواة الأُولى للمجتمع، والتي تلعب دورًا أساسًا في منح أفراد العائلة هوياتهم
الثقافية الخاصة بهم. والقراءة المتأنية لرواية (رجل المرايا المهشمة) تؤشِّر
اشتغال الروائية لبنى ياسين باتجاه رسم شبكة حياة عائلة صطوف من خلال معطيات
يتحكّـم بها تكوين نفسي سلبيّ تطغى سلبياته على ايجابياته، فقد وضعتهم في مواقف
مصيرية صعبة تختبر معادنهم، وتكشفها للمتلقي؛ ولهذا سيقف البحث لدى أبرز المكونات الانفعالية
في رواية (رجل المرايا المهشمة)، مثل الميل الى الانطواء حيث سبق للبحث أن أشار
الى انطواء ديبو، وعدم رغبته في تكوين علاقات وثيقة مع الجيران، لكنَّ حالة
الانطواء تبدو بشكلها الحاد لدى صطوف أكثر من غيره من شخصيات الرواية، فحين قررت
والدته ارساله الى المدرسة مع أخويه ظهرت رغبته في الانطواء؛ لأنّه " يخشى
مواجهة العالم خارج المنزل مدركاً في قرار نفسه أن أحداً لن يقبل عليه، كما لو أنه
حلزون داخل قوقعة ملتصقة بجدار رطب".(106) وذلك بسبب ما ترسّب في نفسه من عدم رغبة الآخرين في اقامة علاقة معه مما
دفعه الى الانطواء والاحباط.
إنَّ القلق - بوصفه عنصرًا نفسيًـا اجتماعيًـا ومكـوِّنًـا انفعاليًـا - هو
" الخوف من المجهول وتجنب المواقف التي يفترض فيها الفرد أن يتعامل أو يتفاعل
مع الآخرين، ويكون معرضًا نتيجة لذلك الى نوع من أنواع التقييم".(107) وهنا يبدو أنَّ الخوف من الوقوع في دائرة نظر الآخرين هو الدافع الأساس
الذي يدفع بالشخصية الى الابتعاد عن أي موقف اجتماعي يجتمع فيه الناس، فشخصية صطوف
" هذا الكائن المعذب المقهور على مدار النص السردي".(108) شخصية تعاني من التوتر والقلق والخوف في أكثر من موقف، على سبيل المثال لا
الحصر خوفه وقلقه من المرأة حيث " أصبح الخوف امرأة، والقلق امرأة، صار يشعر
بقلق شديد واضطراب أشد عندما تقترب احداهن ولو دون قصد من هالته".(109) ويعود سبب هذا الخوف الى ما تراكم في داخله من مشاعر نتيجةً لمعاملة أُمه
له " فالمرأة هي أمه التي ما أحبته يوماً. رغم حبه لها ومحاولته لإرضائها بأي
طريقة تخطر في باله".(110) فالاستبعاد
والإقصاء الذي فرضته أُمه عليه ادّى الى تكوين شعوره بقلق يظهر كلّما تواجد في
مكان فيه امرأة، لأنّه سيفترض أنَّها ستنظر إليه فتتحد شخصيتها بشخصية أُمّه التي
رفضت وجوده، وحرمته من حنانها، كما أنَّ التشوّه الخُلقي الذي ظهر على وجهه منذ
ولادته كان سببًـا مُضافـا لتوقع صطوف أنَّ أيّـة امرأةٍ ستقع عينها على هذا التشوّه
سترفضه، سواء أكان رفضًا ظاهـرًا أم مبطَّـنًا، وهذا بالتالي ما سبب له شعورًا
بالضيق والقلق وفقدان التوازن النفسي عند تواجد امرأة قريبة منه مكانياً، لكنه
تمنَّى أنّ عروسته سحر " ستخلصه من مأساة ضعفه المرضي من النساء، أنها ستعوده
كيف يقترب منهن، ويقتربن منه".(111) لأنّه تصوّر أنَّ امرأة واحدة إن قبلت به كما هو سيتصالح مع خوفه وقلقه واحباطه،
وهذا ما تجلّى في فكرته: "يكفي أن تحبه امرأة واحدة ليحب نفسه بما يكفي
ليتابع حياته ببعض السكينة والرضا، يكفي أن تشعر به امرأة واحدة ليشعر بالأمان وقد
غزا قلبه".(112) فكانت نظرته
هذه للمرأة، والدور الذي ستلعبه بقبولها له سيُحدِث التغيير في حياته، ويمنحه
الأمان، ويخلصه من شعوره بالتهميش والإقصاء، لكنَّ العروس " شعرت في أعماقها
بأنها سجنت في قفص مع قرد بغيض".(113) فلم تتحقق هذه الرغبة لأنَّ عروسته أكملت رحلة تهميشه من خلال شعورها بأنه
قرد بغيض، ورفضت العيش معه فهربت من المنزل، وجـرَّدته بهذا السلوك من إنسانيته
كما فعلت أُمّـه قبلها.
كما يتجلّى الشعور بالقلق من جَرّاء الشعور بالذنب، فالقلق حسب فرويد
" يكون على شكل إحساسات كبيرة بالذنب، يشعره إدراك الضمير، وهو عامل باطني
للسلطة الأبوية والذي يهدد الشخص بالعقاب لإقدامه على ارتكاب فعل قبيح أو مجرد
التفكير في شيء من شأنه أن يثير سخط الأنا".(114) وهذا ما عايشته دلال لأنّـها " هي من فتح الباب لأبي نعيم في تلك
الليلة المشؤومة وهي من استسلم له في نهاية الامر".(115) فهي لم تغفر لنفسها غلطتها بفتح الباب ليلًا بغياب زوجها، كما لم تغفر
استسلامها له لحظة الاغتصاب، وهذا ما جعلها تتوقع أسوأ العواقب بسبب تلك التجربة
السلبية والمقلقة.
تُـعدُّ السلطة هي الحق الشرعي في التصرف وإصدار الأوامر في مجتمع معين.(116) وتتخذ من القوة مظهرًا لها، ومن خلالها يستطيع شخص ما أن يؤثِّـر على سلوك
شخص آخر. (117) وهذا التأثير ناتج عن كونه مركـزًا بحكم امتلاكه لقوة
السلطة. في رواية (رجل المرايا المهمشة) تجلّـت السلطة بأشكال
متعددة، فعندما توفي والد دلال اضطرت الأُم الى أن "توزّع فلذات كبدها على
رجال الحي الذين تهافتوا للمصاهرة في مقايضة لا يزيد ثمنها عن رفع مسؤوليات فتيات
جميلات ثلاث، لا يجدن ما يسد رمقهن، ولا من يحميهن من عيون تسترق النظر بوقاحة،
طالما أنه ليس هناك رجل في البيت لاقتلاع تلك العيون".(118) فالسلطة الذكورية سلطة تتحكم بمجتمعنا العربي، ولا يمكن مواجهتها إلاّ
بسلطة ذكورية مقابلة، فغياب والد دلال بوصفه سلطة مجتمعية تقليدية تعمل على حماية
بناته من سلطة ذكور المجتمع دفع بالأُم الى اتخاذ قرار مصيريّ هو البحث عن سلطة
بديلة لحمايتهن تمثّـلت بالأزواج، فكان زواجهن دون مقابل سوى الحماية، وسدِّ الرمق
في مجتمع له عاداته وتقاليده في زواجٍ فخم المظاهر، ولكنّ زواج دلال وأخواتها أدّى
الى تهميشن، وضياع أحلامهن بمستقبل أفضل، مما جعله قيداً عليهن لكونهن الأضعف في
المجتمع مما يتطلب سلطة ذكورية تحميهن.
عانت المرأة من شتى أنواع التهميش الثقافي والاجتماعي والسياسي بسبب سلطة
المركز المتمثلة بالأُبـوّة. وهي بنية
ثقافية نشأت معتمدة على توصيفات منحها الرجال لأنفسهم تمثّـلت بالايجابية والمغامرة
والعقلانية والإبداع، بينما منحوا المرأة صفات السلبية والرضوخ والارتباك والتردد
والعاطفية واتباع العرف والتقاليد.(119) فـفكرة الرجل (الذكر) قائمة على اختزال وجود المرأة بجسدها، أمّـا هو فعقل،
مما أنتج سيطرة فكرية تحكّم بسببها الرجل بمعطيات الحياة ومفاصلها، فامتلك سلطة
صنع القرار وتنفيذه، وحرم المرأة (الأُنثى) من مساواتها معه، وكان تهميش المرأة
ناتجًـا سلبيًـا لهذه السلطة الذكورية التي سنرى لها أكثر من نموذج في رواية (رجل
المرايا المهشمة)، فتجلّت في تحرّش والد سحر بها بعد وفاة أُمها، ثم اغتصابها،
وإجبارها على الزواج من صطوف، مما جعلها تشعر بالتهميش والضياع والنبذ، كما تجلّـت
أيضاً في اغتصاب أبي نعيم لدلال الذي لم يكتف بالليلة الأُولى بل حاول انتهاك حرمة
بيت ديبو في الليلة التالية، إلاّ ان دلال استعانت بجيرانها مخبرةً إيّـاهم
بأنَّـها سمعت ليلًا طرقًـا على بابها؛ وذلك " ليتولى رجل في بيت آخر أمر
الوقوف في وجه رجل تقوده الشهوة والجنون". (120) وهذا ما حصل فعلًا مما جعل أبو نعيم يغادر " وهو يتعثر بظله ويلوي ذيل
الخيبة ويعض عليه بنواجذه، مدركاً أن الباب الذي فتح له مرة لن يفتح له مرة أخرى
مهما حدث".(121) فسلطة أبي نعيم
الذكورية كان لا بُـدَّ لها من سلطة ذكوريةٍ مقابلة تردعها في غياب السلطة الأصيلة
التي يمثّـلها ديبو زوج دلال، وهي هنا سلطة ايجابية منحت دلال حمايةً من اغتصابٍ
آخر.
إنَّ الشعور بالحرمان ينتج سلوكًـا عدائيًـا عنيفًـا، ففقدان الطفل للعاطفة
الأُسرية الدافئة وتخصيصًا عاطفة الأُم وحمايتها يدفع بالمعتدَى عليه أحيانًـا الى
ردِّ فعلٍ سلطويّ تجاه المعتدي الذي حرمه من حقّـه في العيش في كنف أُسرةٍ ترعاه،
أو تجاه شخصية أُخرى مجرّدة من القوة، وهذا ما فعله صطفوف حين اعتدى على شرف العروس
الميتة، وانتهك حرمتها انتقامًـا من الظلم والتهميش الذي عاشه، فمارس سلطته
العنفية السلبية عليها لينتهي الى مصير تهميشي وإقصائي أيضًا هو عقوبة السجن التي
أوقعها عليه القانون، فالسجن تقييد للحرية وإقصاء واستبعاد عن الحياة المجتمعية
التي لم تعترف به على طول مسار السرد في هذه الرواية، مما دفعه بالتالي الى تهشيم
وجهه فأوقع بذلك عقوبة على نفسه أُضيفت الى عقوبته المجتمعية التي تمثّـلت بالفضيحة
والاستهجان، وعقوبته القانونية التي تجسّدت بقرار سجنه.
ثالثًا: الخاتمة
في نهاية مساره توصّل البحث الى
جملة من النتائج أهمها:
1/ قـدّمت الروائية لبنى ياسين
مجتمعاً روائيًـا مأزومًـا تمثّـل بشخصيات فاقدةٍ لهويتها الثقافية ومهمشة يحاصرها
اليأس، فتحكّـمت بها الأخطاء والمفاسد والمخاسر، وهذا ما وجده البحث متجسّـداً
بشخصيات: صطوف ودلال وديبو وناجي وأبي نعيم وزوجة صطوف.
2/ اختارت الروائية الراوي العليم ساردًا
يتكلم بالنيابة عنها وعن شخصيات الرواية في الوقت ذاته، واحتلَّ موقعًـا خارج
الرواية، ليقدمها بطريقة الإخبار.
3/ الهوية الثقافية هي الأساس الذي تُبنى عليه شخصية
الفرد، وشخصية المجتمع أيضًا لأنها تمنح الفرد شخصية وخصوصية من جهة، وتربطه
بمجتمعه في وحدةٍ ايجابيةٍ اندماجيةٍ من جهةٍ مقابلة.
4/ التهميش حالة سلبية تتمظهر في الجوانب الاجتماعية
والثقافية والاقتصادية والانثروبولوجية للفرد أولًا، وللمجتمع ثانيًـا، وتتعدد
دوافعه في الواقع العياني، لكن دوافعه على مستوى رواية (رجل المرايا المهشمة) تحددت
بــــ: الفقر الذي لعب دورًا كبيرًا في تحديد مسارات الشخصيات ومصائرها، وفقدان
الأُسرة لدورها الحقيقي لتهيئة أفرادها للاندماج الاجتماعي بوصفها المؤسسة الأُولى
لبناء شخصيات أفرادها، والسلطة الذكورية على المرأة الذي أدّى الى اغتصاب أبي نعيم
لدلال وقادها الى الجنون والموت، واغتصاب أبي توفيق لابنته ادّى لكرهها لصطوف
وهربها منه، والإقصاء القسري الذي مارسته دلال مع ابنها صطوف جعل منه نموذجًـا
للمهمش الذي يحاصره الشعور باليأس من تقبل عائلته ومجتمعه له.
5/ إنَّ فقدان الهوية الثقافية للمهمّش تسبب بتفعيل
مشاعر الحرمان والقلق والضياع وفقدان الثقة بالنفس والتبعية للمركز السلطوي، مما
أسهم في قيادتهم الى سلوكيات ومصائر سوداوية.
رابعاً: هوامش البحث:
*لبنى ياسين: كاتبة وروائية وشاعرة وفنانة تشكيلية سورية، أصدرت عدة
مجموعات قصصية هي: ضد التيار، انثى في قفص، طقوس متوحشة، سيراً على أقدام نازفة،
سبعة أزرار وعروتان، ثقب في صدري. نالت جائزة أدب المهجر في هولندا عن قصة (مصلوبة
على جبين الشمس) عام 2014. وتُرجمت قصصها الى عدّة لغات أجنبية. كما أنتجت مجموعة
شعرية تحمل عنوان (تراتيل الناي والشغف)، ومقالات ساخرة بعنوان (شارب زوجتي).(1)
الكاتبة والفنانة لبنى ياسين: العدل في الغربة وطن: اوس أبو عطا Arabic.aputniknews.com
(2) يُنظر: البحث العلمي – الخطوات
المنهجية لإعداد البحوث الاجتماعية: محمد شفيق، المكتب الجامعي الحديث،
الاسكندرية، ط1، 1987، ص84.
(3) يُنظر: الهوية وثقافة السلام:
فؤاد بدوي بطرس، 2008، ص20.
(4) نظرية الثقافة: مجموعة من
الكتاب، تر: علي سيد الصاوي، مراجعة: الفاروق زكي يونس، عالم المعرفة، الكويت، 2002،
د. ط، ص 9.
(5) ينظر: أصول التربية الاجتماعية
والثقافية والفلسفية – رؤية حديثة للتوفيق بين الاصالة والمعاصرة: محمد الشبيبي،
دار الفكر العربي، القاهرة، د. ط، 2000، ص106.
(6) التهميش والمهمشون في المدينة
العربية: عمر الزعفوري، مجلة عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،
الكويت، ع4، مج36، ابريل- يونيو، 2008.
(7) يُنظر: لسان العرب: ابن منظور،
مج15، دار صادر، بيروت، 2004، ص110.
(8) المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية،
مكتبة الشروق الدولية، مصر، ط4، 2004، ص998.
(9) يُنظر: التعريفات: الشريف علي
بن محمد الجرجاني، دار عالم الكتب، بيروت، د. ط، 1998، ص 91.
(10) العولمة وجدل الهوية
الثقافية: حيدر ابراهيم: عالم الفكر، الكويت، مج28، ع2، اكتوبر/ ديسمبر، 1999،
ص104.
(11) حوار الحضارات – حوار هويات
ثقافية: نادية محمود مصطفى مجلة الإنسان والمجتمع، ع3، جامعة تلمسان، 2011، ص
234.
(12) الهوية: اليكس ميكشيللي، تر:
علي وطفة، دار الوسيم، دمشق، ط1، 1995، ص15.
(13) الهوية: حسن حنفي حسنين،
المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط1، 2012 ، ص11.
(14) الحداثة وما بعدها: عبد الوهاب المسيري وآخر، دار الفكر ، دمشق، د. ط،
2003، ص205.
(15) الهوية: حسن حنفي حسنين، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط1، 2012،
ص24.
(16) الهوية: حسن حنفي حسنين، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط1، 2012،
ص25.
(17) يُنظر: لسان العرب ابن منظور،
مج1، ج6، دار صادر، بيروت، ط4، 2004، ص493.
(18) القاموس المحيط: الفيروزآبادي
الشيرازي الشافعي، دار الكتب العلمية، منشورات علي بيضون، ج3، بيروت، ط1، 1999،
ص162.
(19) مشكلة الثقافة: مالك بن نبي،
تر: عبد الصبور شاهين، دار الفكر المعاصر – بيروت – لبنان، ودار الفكر – دمشق –
سوريا، ط4، 1984، ص74.
(20) مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية: دنيس كوش، تر: منير السعيداني،
مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 2007، ص31..
(21) تأويل الثقافات – مقالات مختارة: كليفورد غيرتر، تر: محمد بدوي،
المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط1، 2009، ص52. (22) مدخل الى علم الاجتماع
العام: غي روشيه، تر: مصطفى دندشيلي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، د.
ط، 1983، ص144.
(23) الثقافة العربية المعاصرة – صراع الاحداثيات والمواقع: ابراهيم محمود،
دار الحوار، سورية، ط1، 2003، ص9-10.
(24) الخطة الشاملة للثقافة العربية: المنظمة العربية للتربية والثقافة
والعلوم، تونس: إدارة الثقافة، ط2، د.ت،
ص21.
(25) يُنظر: الهوية: اليكس ميكشيللي، تر: علي وطفة، دار الوسيم، دمشق، ط1،
1995، ص18-20.
(26) الثقافة المختلطة والهوية الثقافية: اوسفالد شفايمر، تر: عبد الحكيم
شباط، موقع الحوار المتمدن. www.ahewar.org
(27) الهوية الثقافية والنقد
الأدبي: جابر عصفور، دار الشروق، القاهرة، ط1، 2010، ص113.
(28) الأدب ومذاهبه: محمد مندور، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة،
ط2، 2002، ص 82- 83.
(29) في نظرية الأدب: شكري عزيز الماضي، دار الحداثة للطباعة والنشر
والتوزيع، لبنان، ط1، 1986، ص85.
(30) لسان العرب: ابن منظور، مج
15، دار صادر، بيروت، ط3، 2004، ص92.
(31) مفهوم التهميش وأشكاله: عادل ابراهيم شالوكا، صحيفة الراكوبة: www.alrakoba.net.
(32) يُنظر: التمكين الاقتصادي للمرأة كمدخل للتمكين الاجتماعي: أيهم أسد: Syrianownews.com.
(33) يُنظر: لغة التهميش – سيرة الذات المهمشة: عبد العاطي الهواري، دار
الإعلام، حكومة الشارقة، دولة الامارات العربية، ط1، 2008، ص9-10.
(34) الحماية الاجتماعية للفقراء: صلاح هاشم، اطلس للنشر والانتاج
الإعلامي، الجيزة – مصر، د. ط، 2018، ص15.
(35) يُنظر: اشكالية المنهج في النقد الأدبي: محمد طرشونة، مركز النشر
الجامعي، تونس، ط1، 2008، ص81.
(36) يُنظر: الباحث الاجتماعي في الأدب – قراءة سوسيوثقافية: هويدا صالح،
دار رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط1، 2015، ص28.
(37) المعجم الفلسفي: ابراهيم مدكور، الهيئة العامة لشؤون المطابع،
القاهرة، د. ط، 1983، ص101.
(38) نظرية الأدب: رينيه ويليك واوستن وارين، المؤسسة العربية للدراسات
والنشر، بيروت، ط2، 1982، ص229.
(39) البطل الروائي: محمد عزام، الموقف الأدبي، دمشق، ع364، 2000، ص49.
(40) رجل المرايا المهشمة، ص48.
(41) نفسه، ص49.
(42) نفسه، ص51.
(43) سيميائية العنوان في مقام البوح لعبد الله العيش: شادية شقروش،
الملتقى الوطني الاول: السيمياء والنص الأدبي، منشورات جامعة بسكرة، 6-7 نوفمبر،
2000، ص271.
(44) رجل المرايا المهشمة، ص 112.
(45) نفسه، ص153.
(46) نفسه، ص34.
(47) نفسه، ص14.
(48) نفسه، ص35.
(49) نفسه، ص34-35.
(50) نفسه، ص10.
(51) نفسه ص10.
(52) نفسه، ص10.
(53) نفسه، ص10.
(54) نفسه، ص35.
(55) نفسه، ص35.
(56) نفسه، ص18.
(57) نفسه، ص181.
(58) نفسه، ص128.
(59) نفسه، ص128.
(60) يُنظر: اشكالية المكان في النص الأدبي: ياسين النصير، دار الشؤون
الثقافية العامة، بغداد، ط1، 1986، ص64.
(61) رجل المرايا المهشمة، ص7.
(62) الفقر وتوزيع الدخل في الوطن العربي: عبد الرزاق الفارس، مركز دراسات
الوحدة العربية، د. ط، بيروت ، 2001، ص21.
(63) رجل المرايا المهشمة، ص7.
(64) نفسه، ص8.
(65) يُنظر: جماليات المكان:
غاستون باشلار، تر: غالب هلسا، المؤسسة الجامعية للنشر، بيروت، ط2، 1984، ص38.
(66) رجل المرايا المهشمة، ص63.
(67) نفسه، ص101.
(68) نفسه، ص10.
(69) نفسه، ص10.
(70) نفسه، ص189.
(71) يُنظر: قاموس علم الاجتماع: محمد عاطف غيث، دار المعرفة الجامعية، ط2،
2006، ص414.
(72) رجل المرايا المهشمة، ص189.
(73) نفسه، ص192.
(74) نفسه، ص258.
(75) نفسه، ص259.
(76) فلسفة الملابس: تومى كاريل، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2001، د.
ط، ص35.
(77) يُنظر: الملبس والهوية
الثقافية بين الانتماء والاغتراب.. رؤية انثروبولوجية: فؤاد غازي، www.iasj.net
(78) رجل المرايا المهشمة، ص 112.
(74) نفسه، ص120.
(80) نفسه، ص121.
(81) دراسة في سيكولوجية الملابس: علية احمد عابدين، 2000، د. ط، دار الفكر
العربي، القاهرة، ص45.
(82) رجل المرايا المهشمة، ص126.
(83) يُنظر: أُصول التربية
والتعليم: زكية ابراهيم كامل ونوال ابراهيم شلتون، دار الوفاء لدنيا الطباعة
والنشر، د. ط، 2008، ص37.
(84) يُنظر: الاجتماع الثقافي: جلال مدبولي، دار الثقافة للطباعة والنشر،
القاهرة، 1979، ط1، ص75.
(85) يُنظر: التراث بين الحضارة وتحديات المستقبل: شرف نصر الله، مكتبة النهضة
المصرية، القاهرة، 1989، د. ط ، ص87. (86) يُنظر: القيم والعادات الاجتماعية – مع
بحث ميداني لبعض العادات: فوزية ذياب، دار النهضة العربية، بيروت، 1980، ص186.
(87) رجل المرايا المهشمة، ص12.
(88) نفسه، ص12.
(89) نفسه، ص12.
(90) يُنظر: الدراسات الشعبية بين
النظرية والتطبيق: نبيلة ابراهيم، مكتبة القاهرة، القاهرة، 1976، د. ط، ص124.
(91) يُنظر: معجم علم الاجتماع: دنكن ميتشل، تر: احسان محمد الحسن، دار
الطليعة للطباعة، بيروت، ط1، 1981، ص 176. (92) رجل المرايا المهشمة، ص76.
(93) رجل المرايا المهشمة، ص76.
(94) نفسه، ص76.
(95) نفسه، ص76.
(96) نفسه، ص87.
(97) نفسه، ص79.
(98) يُنظر: موسوعة علم الاجتماع: احسان محمد الحسن، الدار البيضاء
للموسوعات، ط1، بيروت، 1999، ص 45.
(99) الاتجاهات الأساسية في علم الاجتماع: علي عبد الرزاق جلبي، دار
المعرفة الجامعية، الازاريطة، د. ط، 2000، ص142.
(100) رجل المرايا المهشمة، ص22.
(101) نفسه، ص26.
(102) نفسه، ص23.
(103) نفسه، ص24.
(104) نفسه، ص24.
(105) علم الاجتماع – المفاهيم
الأساسية: سكوت جون، تر: محمد عثمان، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، 2009،
ص 132.
(106) رجل المرايا المهشمة، ص64.
(107) القلق الاجتماعي – دراسة ميدانية لتقنين مقياس القلق الاجتماعي على
عينات سورية: سامر رضوان، مجلة مركز البحوث التربوية، ع19، ص47، 2001.
(108) رواية لبنى ياسين (رجل المرايا المهشمة): نبيلة احمد علي، موقع صحيفة
النور: www.ainoor.se
(109) رجل المرايا المهشمة، ص97.
(110) نفسه، ص99.
(111) نفسه، ص219.
(112) نفسه، ص219.
(113) نفسه، ص221.
(114) القلق: سيجموند فرويد: القلق، تر: عثمان نجاتي، دار النهضة العربية،
القاهرة، ط2، 1962، ص211.
(115) رجل المرايا المهشمة، ص40.
(116) يُنظر: علم الاجتماع السياسي: مولود زايد الطيب، منشورات جامعة
السابع من ابريل، بنغازي، ط 1، ص76.
(117) يُنظر: النظرية السياسية – مقدمة: اندرو هيوود، ترجمة: لبنى الريدي،
المركز القومي للترجمة، القاهرة، 2013، ط1 ، ص225.
(118) رجل المرايا المهشمة، ص14.
(119) يُنظر: مدخل في نظرية النقد
النسوي وما بعد النسوية – قراءة في سفر التكوين النهائي: حفناوي يعلي، الدار
العربية للعلوم ناشرون – بيروت، منشورات الاختلاف – الجزائر، ط1، 2009، ص46.
(120) رجل المرايا المهشمة، ص27.
(121) نفسه، ص28.
خامساً: مصادر البحث ومراجعه:
أولاً : المصدر: رجل المرايا المهشمة: لبنى ياسين، دار الغاوون،
بيروت، د. ط، 2012.
ثانياً: المراجع:
أ/ الكتب الورقية:
1/ الاجتماع الثقافي: جلال مدبولي، دار الثقافة للطباعة
والنشر، القاهرة، ط1، 1979.
2/ الأدب ومذاهبه: محمد مندور، دار نهضة مصر للطباعة
والنشر، القاهرة، ط2، 2002.
3/ اشكالية المكان في النص الأدبي: ياسين النصير، دار
الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط1، 1986.
4/ اشكالية المنهج في النقد الأدبي: محمد طرشونة، مركز
النشر الجامعي، تونس، ط1، 2008.
5/ أصول التربية الاجتماعية والثقافية والفلسفية – رؤية
حديثة للتوفيق بين الاصالة والمعاصرة: محمد الشبيبي، دار الفكر العربي، القاهرة،
د. ط، 2000.
6/ أُصول التربية ونظم التعليم: زكية ابراهيم كامل ونوال
ابراهيم شلتون، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الاسكندرية، ط1، 2008.
7/ الباحث الاجتماعي في الأدب – قراءة سوسيوثقافية:
هويدا صالح، دار رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط1، 2015.
8/ البحث العلمي
– الخطوات المنهجية لإعداد البحوث الاجتماعية: محمد شفيق، المكتب الجامعي الحديث،
ط1، 1085.
9/ تأويل الثقافات – مقالات مختارة: كليفورد غيرتر، تر:
محمد بدوي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط1، 2009.
10/التراث بين
الحضارة وتحديات المستقبل: شرف نصر الله، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، د. ط،
1989.
11/ التعريفات:
الشريف علي بن محمد الجرجاني، دار عالم الكتب، بيروت، د. ط، 1998.
12/ الثقافة العربية المعاصرة – صراع الاحداثيات
والمواقع: ابراهيم محمود، دار الحوار، سورية، ط1، 2003 .
13/ جماليات المكان: غاستون باشلار، تر: غالب هلسا،
المؤسسة الجامعية للنشر، بيروت، ط2، 1984.
14/ الحداثة وما بعدها: عبد الوهاب المسيري وآخر، دار
الفكر، دمشق ، د. ط، 2003.
15/ الحماية الاجتماعية للفقراء: صلاح هاشم، اطلس للنشر
والانتاج الإعلامي، الجيزة – مصر، د. ط، 2018.
16/ الخطة الشاملة للثقافة العربية: المنظمة العربية
للتربية والثقافة والعلوم، ط2، تونس: إدارة الثقافة، د.ت.
17/ الاتجاهات الأساسية في علم الاجتماع: علي عبد الرزاق
جلبي، دار المعرفة الجامعية، الازاريطة، د. ط، 2000.
18/ الدراسات الشعبية بين النظرية والتطبيق: نبيلة
ابراهيم، مكتبة القاهرة، القاهرة، د. ط، 1976.
19/ سيميائية العنوان في مقام البوح لعبد الله العيش:
شادية شقروش، الملتقى الوطني الاول: السيمياء والنص الأدبي، منشورات جامعة بسكرة،
6-7 نوفمبر، د. ط، 2000.
20/ علم الاجتماع السياسي: مولود زايد الطيب، منشورات
جامعة السابع من ابريل، بنغازي، ط 1، 2007
21/ علم الاجتماع – المفاهيم الأساسية: سكوت جون، تر:
محمد عثمان، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، 2009.
22/ الفقر وتوزيع الدخل في الوطن العربي: عبد الرزاق
الفارس، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، د. ط ، 2001.
23/ فلسفة
الملابس: تومى كاريل، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، د. ط، 2001.
24/ في نظرية الأدب: شكري عزيز الماضي، دار الحداثة
للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، ط1، 1986.
25/ قاموس علم الاجتماع: محمد عاطف غيث، دار المعرفة
الجامعية، ط2، 2006.
26/ القاموس المحيط: الفيروزآبادي الشيرازي الشافعي، دار
الكتب العلمية، منشورات علي بيضون، ج3، بيروت، ط1، 1999.
27/ القلق: سيجموند فرويد: القلق، تر: عثمان نجاتي، دار
النهضة العربية، القاهرة، ط2، 1962.
28/ القيم والعادات الاجتماعية – مع بحث ميداني لبعض
العادات: فوزية ذياب، دار النهضة العربية، بيروت، ط1، 1980.
29/ لسان العرب: ابن منظور، مج15، دار صادر، بيروت، ط4،
2004.
30/ لغة التهميش – سيرة الذات المهمشة: عبد العاطي
الهواري، دار الإعلام، حكومة الشارقة، دولة الامارات العربية، ط1، 2008.
31/ مدخل الى علم الاجتماع العام: غي روشيه، تر: مصطفى
دندشيلي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1983.
32/ مدخل في نظرية النقد النسوي وما بعد النسوية – قراءة
في سفر التكوين النهائي: حفناوي يعلي، الدار العربية للعلوم ناشرون – بيروت،
منشورات الاختلاف – الجزائر، ط1، 2009.
33/ مشكلة الثقافة: مالك بن نبي، تر: عبد الصبور شاهين،
دار الفكر المعاصر – بيروت – لبنان، ودار الفكر – دمشق – سوريا، ط4، 1984.
34/ معجم علم الاجتماع: دنكن ميتشل، تر: احسان محمد
الحسن، دار الطليعة للطباعة، بيروت، ط1، 1981.
35/ المعجم الفلسفي: ابراهيم مدكور، الهيئة العامة لشؤون
المطابع، القاهرة، 1983.
36/ المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية، مكتبة الشروق
الدولية، مصر، ط4، 2004.
37/ مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية: دنيس كوش، تر:
منير السعيداني، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 2007.
38/ موسوعة علم الاجتماع: احسان محمد الحسن، الدار
البيضاء للموسوعات، ط1، بيروت، 1999.
39/ نظرية
الأدب: رينيه ويليك واوستن وارين، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط2،
1982.
40/ نظرية
الثقافة: مجموعة من الكتاب، تر: علي سيد الصاوي، مراجعة: الفاروق زكي يونس، عالم
المعرفة، الكويت، د. ط، 2002.
41/ النظرية السياسية – مقدمة: اندرو هيوود، ترجمة: لبنى
الريدي، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ط1، 2013.
42/ الهوية:
اليكس ميكشيللي، تر: علي وطفة، دار الوسيم، دمشق، ط1، 1995.
43/ الهوية: حسن
حنفي حسنين، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط1، 2012.
44/ الهوية الثقافية والنقد الأدبي: جابر عصفور، دار
الشروق، القاهرة، ط1، 2010.
ب/ الكتب الالكترونية
1/ الهوية وثقافة السلام: فؤاد بدوي بطرس، 2008: www.kobayat.org
ج/ المجلات الورقية:
1/ البطل الروائي: محمد عزام، الموقف الادبي، دمشق، ع4،
مج36، 2000.
2/ التهميش والمهمشون في المدينة العربية: عمر الزعفوري،
مجلة عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ع4، مج36،
ابريل- يونيو، 2008.
3/ حوار الحضارات – حوار هويات ثقافية: نادية محمود
مصطفى، مجلة الإنسان والمجتمع، ع3، جامعة تلمسان، 2011.
4/ العولمة وجدل الهوية الثقافية: حيدر ابراهيم: عالم
الفكر، الكويت، مج28، ع2، اكتوبر/ ديسمبر، 1999.
5/ القلق الاجتماعي – دراسة ميدانية لتقنين مقياس القلق
الاجتماعي على عينات سورية: سامر رضوان، مجلة مركز البحوث التربوية، ع19، ص47،
2001.
د/ المواقع الالكترونية:
1/ التمكين الاقتصادي للمرأة كمدخل للتمكين الاجتماعي:
أيهم أسد: Syrianownews.com
2/ الثقافة المختلطة والهوية الثقافية: اوسفالد شفايمر،
تر: عبد الحكيم شباط، موقع الحوار المتمدن: www.ahewar.org
3/ رواية لبنى ياسين (رجل المرايا المهشمة): نبيلة احمد
علي، موقع صحيفة النور: www.ainoor.se
4/ الكاتبة
والفنانة لبنى ياسين: العدل في الغربة وطن: اوس أبو عطا: Arabic.aputniknews.com
5/ مفهوم التهميش وأشكاله: عادل ابراهيم شالوكا، صحيفة
الراكوبة: www.alrakoba.net.
6/ الملبس والهوية الثقافية بين الانتماء والاغتراب..
رؤية انثروبولوجية: فؤاد غازي، www.iasj.net
2020م
·
نُـشِر في مجلة
مدارات الثقافية، المغرب، عدد مزدوج 51/ 52، يوليوز وغشت، السنة الخامسة، 2024م.